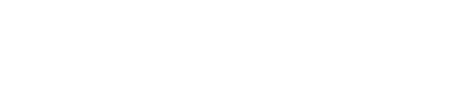يبدو أن البشر قد أنجزوا “مهمة” تلويث الأرض وأنهارها ومحيطاتها وغلافها الجوي على نحو شامل ودقيق، بحسب الصحفية راشيل نوير. لكن السؤال يبقى: هل هناك أي بقعة لم يمتد إليها التلوث على وجه هذا الكوكب؟
في وقت ما، وفي الفترة ما بين 1.8 مليون و12 ألف سنة في الماضي، أتقن أسلافنا عملية إشعال النار.
وفي أغلب الأحيان، يعتبر الباحثون في الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) هذا الحدث بمثابة الشرارة التي أتاحت لنا الفرصة لكي نصبح بشرا بكل معنى الكلمة، إذ أن ذلك منحنا الوسائل اللازمة للطهي وللحفاظ على أن تتمتع أجسادنا بالدفء، وكذلك السبل التي مكنتنا من صناعة الأدوات المختلفة.
ولكن تعلم كيفية إشعال النار مثّل تطورا مهما آخر بالنسبة لنا، ألا وهو “اختراع” ظاهرة التلوث الناجم عن أنشطة الإنسان المختلفة.
وبحكم تعريفه، يتمثل التلوث في إدخال شئ ما على البيئة من شأنه الإخلال بنظامها على نحو مؤذٍ وضار.
وفي الوقت الذي تنجم عن الطبيعة، في بعض الأحيان، ملوثاتها ذات التأثير المدمر؛ من قبيل حرائق الغابات التي تؤدي لتصاعد سحب الدخان والرماد، وكذلك البراكين التي تقذف بالغازات السامة في الجو، فإن للبشر نصيب الأسد من المسؤولية عن ظاهرة التلوث التي يُبتلى بها كوكبنا في الوقت الحاضر.
فعلى ما يبدو، نتمتع نحن – البشر – بموهبة ترك مخلفاتنا وقمامتنا خلفنا أينما نذهب. فحتى إذا ما قصد المرء البقاع الأكثر نأيا وبعدا على وجه الأرض، سيكون بوسعه رصد ذلك بنفسه على نحو مباشر.
فإطارات السيارات الممزقة، والقارورات البلاستيكية تتناثر على مساحة واسعة من صحراء غوبي، مترامية الأطراف الواقعة في الجزء الشرقي من وسط آسيا.
كما أن الأكياس البلاستيكية تطفو فوق التيارات المائية في قلب المحيط الهادئ، بالإضافة إلى أن أسطوانات الأكسجين المستخدمة والفارغة، وأيضا مياه الصرف الصحي تلطخ وتشوه الثلوج على قمة جبل إيفرست.
وبرغم ذلك، لا يزال العالم مكانا فسيحا. فهل هناك بعض المعاقل الأخيرة الخالية من التلوث الذي صنعناه بأيدينا؟
الإجابة على هذا السؤال ربما تكون أكثر دقة إذا ما قسّمنا النظام البيئي إلى أربعة عوالم مختلفة: السماء، الأرض، المياه العذبة أو النقية، والمحيطات.
يتجسد تلوث الهواء في العديد من الأشكال. والضباب الدخاني، وهو المصطلح الذي يطلقه البعض على تلوث الهواء أيا كان شكله، يتكون في الغالب من مزيج من الجسيمات الدقيقة وغاز الأوزون، وهو ضمن ما يُعرف بغازات الدفيئة، تلك التي تتميز بقدرتها على امتصاص الأشعة تحت الحمراء.
وينجم هذا الغاز عن تفاعل الأكاسيد النيتروجينية من جهة، والمركبات العضوية المتطايرة الناتجة عن عوادم السيارات وأنشطة المصانع من جهة أخرى، معا في وجود ضوء الشمس.
وتفيد المعطيات بأن تأثيرات مثل هذا النوع من التلوث على البيئة وصحة الإنسان قد تكون خطيرة.
ففي الهند وحدها، يؤدي التلوث الناجم عن ارتفاع نسبة الأوزون إلى تكبيد البلاد خسائر في المحاصيل الزراعية بقيمة تناهز 1.2 مليار دولار سنويا.
أما فيما يتعلق بصحة الإنسان، فإن تلوث الهواء – وهو المتعلق بتدني جودة الهواء خارج المباني والمنازل – يودي بحياة نحو مليون إنسان كل عام. أما تلوث الهواء بداخل المنازل والمباني، والذي ينجم عادة عن استخدام النار في الطهي، فيؤدي إلى وفاة نحو مليونيّ شخص سنويا.
وعندما تجد غازات مثل أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين، وغيرهما من المواد التي تُعرف باسم الملوثات الأساسية أو الأولية، طريقها صعودا إلى الغلاف الجوي، فإنها تتحول على الأغلب عبر تفاعلات كيميائية، إلى ما يسميه العلماء “ملوثات ثانوية”.
وبينما تمكث بعض هذه الملوثات في الأجواء لعدة أشهر، فإن ملوثات أخرى، مثل غاز الميثان، تتسم بأنها أقل نشاطا وتفاعلا، ويمكن أن تدور في أرجاء المعمورة لأعوام حتى تتفتت في نهاية المطاف، وتسقط على سطح الأرض مُحملة على ذرات الثلوج أو قطرات المطر.
وكما تشير هيلين آب سيمون، الأستاذة المتخصصة في دراسات تلوث الهواء بكلية إمبريال كوليدج للعلوم والتكنولوجيا والطب في لندن، فإن ذلك يعني أن “ابتعاد المرء مسافات أكبر عن مصادر تلوث الهواء لا يعني بالضرورة قدرته على الإفلات منه”.
وانبعاث الملوثات في الهواء يجعلها تنتقل لمسافات واسعة بفعل الرياح والتيارات الهوائية التي تسود الغلاف الجوي.
ويقول دافيد إدواردز، المدير بالمركز الوطني للدراسات المتعلقة بالغلاف الجوي في منطقة بولدر بولاية كلورادو الأمريكية إن “ما نراه في الكثير من الأحيان أن التلوث يبدأ في مكان ما، ولكن ينتهي به المطاف في مكان آخر بعيد للغاية” عن البقعة التي بدأ فيها.
ولذا، فاستنادا إلى ما نعرفه عن تيارات الهواء في الغلاف الجوي، وكذلك التوزيع الخاص بالمواد المُلَوِثة؛ فإن بوسعنا القول باطمئنان إنه ليس ثمة بقعة على وجه هذا الكوكب يمكن أن نضمن خلوها تماما من تلوث الهواء.
وينطبق ذلك بالتالي على الوضع على سطح الأرض.
لكن هذا يعني، في الوقت ذاته، أن ثمة بقاعا في العالم تتميز بكون الهواء فيها أكثر نقاءً من غيرها. وبشكل عام، يمكن القول إن الهواء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية أفضل حالا من مثيله في النصف الشمالي، فقط بفضل حقيقة أن عدد من يقطنون في النصف الجنوبي أقل من نظرائهم في النصف الشمالي.
وبينما تدور المواد الملوِّثة حول العالم، فإنها لا تنتقل كثيرا ذهابا وإيابا بين نصفي الكرة الأرضية، بفعل أنماط هبوب الرياح، التي تشكل ما يشبه الحواجز بين النصفين. ولهذا السبب، ربما يكون القطب الجنوبي هو البقعة الأكثر خلوا من تلوث الهواء على وجه الأرض، بالنظر إلى موقعه النائي على سطح الكوكب.
لكن كما تقول آب سيمون فإنه لا يزال هناك ثقب هائل، سببّه التلوث، في طبقة الأوزون القائمة فوق القارة القطبية الجنوبية. كما أنه يمكن للمرء أن يرصد بسهولة وجود كميات من الكربون الأسود فوق ثلوج هذه القارة.
ولذا، فحتى ما إذا كان من المرجح أن يتميز هواء القطب الجنوبي بأنه الأكثر نقاءً على وجه الأرض، فإن هذه المنطقة لا يمكن اعتبارها، بأي حال من الأحوال، بقعة بكراً خالية تماما من التلوث.
المياه

يؤثر تلوث الهواء، للأسف على حالة المياه في العالم، وهو ما يبدد الآمال في إمكانية وجود مسطحات مياه عذبة تتسم بالنقاء التام على وجه الأرض.
ويقول توماس تشيرامبا مسؤول وحدة النظام البيئي للمياه العذبة ببرنامج البيئة بالأمم المتحدة – ومقره العاصمة الكينية نيروبي – إنه “إذا نظر المرء إلى مسألة التلوث بصورة عامة، فسيجد أنه من غير المرجح أن تكون هناك مستجمعات مائية لا تزال بكرا لم تتلوث في أي مكان على وجه الأرض، نظرا لأن (الظواهر الناجمة) عن التدخلات البشرية مثل تلوث الهواء، قد انتشرت حقا في كل أنحاء العالم”.
ولكن بينما تجد المواد المسببة لتلوث الهواء مستقرا لها في المياه، فإن نظيرتها المسببة للتلوث على اليابسة هي التي تلعب الدور الرئيسي في تلويث مصادر المياه العذبة.
فالمواد الكيمياوية والأسمدة والنفايات تتسرب إلى المياه الجوفية ثم تنجرف في البحيرات والأنهار والمجاري المائية، لينتهي بها المطاف على الأغلب بالوصول إلى مياه المحيطات.
نتيجة لذلك، ينشأ ما يُعرف بالمناطق الميتة، وهي عبارة عن مساحات من المياه العذبة أو المالحة الخالية من مظاهر الحياة.
وتظهر مثل هذه المناطق عندما تسبب المواد الغذائية المُحملة من على اليابسة انتشارا جرثوميا واسع النطاق في المياه، وهو ما يؤدي بدوره إلى استهلاك الأكسجين الموجود فيها واستنزافه تماما.
ويمكن العثور على “قنوات الموت” هذه في مختلف أنحاء العالم، ولكن المثال الأكثر شهرة في هذا المضمار سيء السمعة يتمثل في خليج المكسيك الواقع في دلتا نهر الميسيسبي.
وتشكل مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية العوامل الرئيسية التي تلحق الدمار والتلوث بالمياه العذبة.
وفي العديد من الدول، يشير مصطلح “صرف صحي” إلى إزالة النفايات والمخلفات من المنازل فقط، وليس معالجتها قبل إعادتها إلى النظام البيئي من جديد.
ووفقا لبعض التقديرات، يتم تصريف 80 في المئة من مياه الصرف الصحي في الدول النامية عبر إلقائها مباشرة في المجاري المائية المحلية.
وربما تكون التقديرات أكثر سوءا، إذا ما تحدثنا عن كل دولة على حدة؛ ففي العاصمة الهندية نيودلهي، تتخلص السلطات المحلية من 99 في المئة من مياه الصرف الصحي في نهر يامونا. أما في العاصمة المكسيكية مكسيكوسيتي فيتم ضخ كل النفايات السائلة في وادي ميزكويتال.
وبنظر أسيت بيسواس، مؤسس مركز العالم الثالث للتحكم في المياه، ومقره المكسيك، تشكل مثل هذه الأنشطة “المصدر الرئيسي للتلوث في مختلف أنحاء العالم”.
ويضيف بيسواس، وهو أستاذ زائر ذو مكانة مرموقة في كلية “لي كوان يو” للسياسة العامة في سنغافورة، أنه “نتيجة لذلك، صارت الأنهار ملوثة، وهو ما يجعل السكان القاطنين على طول مجاري هذه الأنهار مرغمين على شرب تلك المياه”.
ووفقا لدراسة أجراها بيسواس، فإنه لا يوجد من بين سكان منطقة جنوب آسيا، والبالغ تعدادهم نحو 1.65 مليار نسمة، من يحظى بفرصة الحصول على مياه صنبور آمنة ونظيفة.
كما تشير الدراسة إلى أن أكثر من نصف الأنهار والبحيرات الموجودة في الصين ملوثة للغاية بما لا يسمح بالشرب من مياهها. وأظهرت أن 72 في المئة من عينات المياه التي جُمعت من مصادر المياه في باكستان غير صالحة للاستخدام الآدمي.
من البديهي القول إن ما يضر الإنسان يضر البيئة أيضا. وبحسب تقرير صدر مؤخرا عن برنامج الأغذية العالمي فإن عدد الحيوانات التي تعيش على المياه العذبة تراجع بنسبة 75 في المئة على مدار السنوات الأربعين الماضية، وهو ما يُعزى بشكل كبير إلى التلوث.
المحيطات
حتى المحيطات، التي تغطي مساحة هائلة من سطح الأرض تصل إلى 70 في المئة منها، لم تسلم من وصول آثار التلوث إليها، وذلك على الرغم من أنها لا – بشكل عام – غير مستكشفة بالكامل حتى الآن.
ففي الوقت الحاضر، يُعزى ما يتراوح بين 60 إلى 80 في المئة من مظاهر التلوث في الحياة البحرية إلى أنشطة تجري على اليابسة، والتي تصل آثارها إلى المياه عبر الموانئ والشواطئ والمناطق الساحلية التي تتسم بالقذارة، وكذلك مياه الصرف الصحي الملوثة التي يتم تصريفها في مياه البحار والمحيطات.
وإذا تحدثنا عن المواد الملوثة للمحيطات، فسنجد أن البلاستيك يشكل المادة الأكثر انتشارا في هذا الصدد.
ويعود ذلك لأن المواد البلاستيكية، تستغرق قرونا وربما أكثر من ذلك، لتتحلل تماما وتتلاشى. وعلى الجانب الآخر، يتحلل الورق على نحو أكثر سرعة. أما الزجاج فليس منتشرا كما كان معتادا في السابق.
المفاجئ في الأمر، أن بعض البقاع النائية للغاية في المحيطات هي كذلك من أكثر البقاع تلوثا نظرا لأنماط التيارات البحرية.
فعلى سبيل المثال، توجد في منتصف ما يُعرف بالمحيط الهادي الشمالي بقعة من اليابسة تحمل اسم “ميدواي أتول”.
وعلى الرغم من أن هذه المنطقة غير مأهولة ومخصصة للعلماء للقدوم إليها في زيارات لا تستغرق أكثر من بضعة أسابيع، فإنها مغطاة بكميات من الأنقاض والحطام التي انجرفت إليها، والتي تجد طريقها في أغلب الأحيان، وعلى نحو مميت، إلى الجهاز الهضمي لطيور البحر التي تعيش هناك.
وفي النهاية، وبغض النظر عما إذا كانت المواد المُلَوِثة التي نتسبب نحن في وجودها، تأخذ شكل وجبة غداء مهملة، أو فضلات بشرية، أو مليارات الأطنان المترية من الملوثات التي تنتقل عبر الهواء، فإننا بتنا إزاء إجابة محزنة وواضحة في الوقت ذاته للسؤال الذي طرحناه في بداية هذه السطور، ألا وهي أنه ما من بقعة على وجه الأرض خالية من التلوث.
أو بعبارة أخرى، وكما قال بيسواس ساخرا “إننا، نحن البشر، قمنا بمهمة رائعة فيما يتعلق بتلويث البيئة من حولنا”.