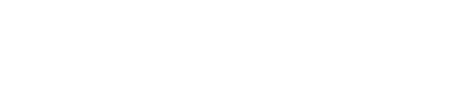يعتقد كثيرون أن علاقة تغير المناخ بالحراك الاجتماعي والثورات غير واقعية. لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى خبراء بيئيين يعتبرون أن تغير المناخ عجّل حلول الربيع العربي. سنوات الجفاف والتصحر، وشح مخزون المياه الصالحة للشرب، وتقلص المساحات المزروعة عاماً بعد عام، كانت من العوامل المساهمة في تهيئة ظروف عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في بلدان مثل سورية ومصر وتونس والجزائر وليبيا. يضاف إليها تغير النسيج الاجتماعي بين وافدين جدد، سواء من الأرياف أو من خارج الحدود، والمقيمين في المدن أو سكان البلد الأصليين، فضلاً عن ازدياد الهوة الطبقية الاجتماعية، والتنافس على فرص العمل والموارد الطبيعية ولا سيما المياه.
في الأعوام الماضية، كثر الحديث عن علاقة بنيوية بين الجفاف في الصين وروسيا وما يسببه من تراجع المحاصيل الزراعية وازدياد أسعار الغذاء العالمية، وتحركات معيشية في بلدان مثل مصر. فثورة الرغيف المصرية عام 2008 جاءت احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدقيق، الذي يُستورد بمعظمه من روسيا. وكانت بمثابة بداية الحراك الثوري الذي تضخم ككرة ثلج حتى أودى بنظام حكم دام أكثر من ثلاثة عقود. وبصرف النظر عن الموجبات أو العوامل السياسية الداخلية والخارجية التي شكلت المحرك الأساس في إحداث التغيير، تبقى للعوامل الاقتصادية والمعيشية كلمة في إنجاحه، وربما إفشاله في مرحلة لاحقة مع استفحال الأزمة الاقتصادية ووقوف البلاد على شفير الإفلاس.
عولمة الأخطار من الصين إلى مصر
خلصت دراسة أصدرها «مركز التقدم الأميركي» في واشنطن أواخر شباط (فبراير) 2013 إلى أن تغير المناخ له تأثير مضاعف في العالم العربي في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية والديموغرافية في العالم. فهو يضاعف محفزات الاضطرابات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بما فيها الجفاف وشح المياه وانعدام الأمن الغذائي والهجرة. وتتوقع الدراسة، وعنوانها «الربيع العربي وتغير المناخ»، أن يستمر هذا الأمر خلال المرحلة الانتقالية التي تمر فيها بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تربط تحديداً بين ظروف المناخ الاستثنائية وما شهده العالم من ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء بين عامي 2010 و2011. فتضاعُف أسعار القمح العالمية من 157 دولاراً للطن في حزيران (يونيو) 2010 إلى 326 دولاراً في شباط 2011 أثّر في شكل ملحوظ في إمدادات الغذاء وتوافره في مصر، التي شهدت ثورتي رغيف، الأولى في 1977 حين قتل 77 شخصاً. فالخبز يشكل ثلث الحصة الغذائية الفردية في مصر، التي تتكبد 38 في المئة من دخلها على الغذاء و3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على دعم القمح. ويزيد الطين بلة ضعف فاعلية السياسات الحكومية، التي أدت إلى نتائج معاكسة في ظل نظام استبدادي، وفق الدراسة.
يظهر النموذج المصري مدى تأثير الأخطار الطبيعية في عالمنا الوثيق الاتصال في الأنظمة الاقتصادية (الأسعار) والسياسية (الاستقرار الحكومي) والبشرية (إمدادات الغذاء)، وهو ما تسمّيه الدراسة «عولمة الأخطار». فالعوامل المناخية، وتحديداً الجفاف وموجات الحر والحرائق، أدت إلى تراجع إنتاج القمح في روسيا مثلاً بنسبة 33 في المئة، وفي أوكرانيا بنسبة 19 في المئة، بينما سبّب ازدياد المتساقطات وبرودة الطقس في كندا تراجعاً في إنتاج القمح بنسبة 14 في المئة، وفائض الأمطار في أوستراليا تراجعاً بحوالى 9 في المئة. أما في الصين، أكبر منتج ومستهلك للقمح في العالم، فانخفض إنتاج القمح 0,5 في المئة، فيما ازداد الاستهلاك 1,68 في المئة. وإذا أخذنا في الاعتبار أن 6 من أصل 18 في المئة من الإنتاج العالمي من القمح يعبر الحدود، يصبح من البدهي أن يساهم نقص الإمدادات العالمية في رفع الأسعار ويخلف آثاراً اقتصادية خطيرة على بلدان مثل مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم بـ9,8 مليون طن عام 2010.
يرى الدكتور مصطفى كمال طلبة، المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن التحولات الجذرية في دول الربيع العربي «استهدفت الانتقال من حكم ديكتاتوري أليم إلى بدايات حكم ديموقراطي سليم. لكن الإدارات الجديدة المتفتحة لم تتحدث بأي صورة واضحة عن حماية البيئة والإدارة السليمة لموارد الثروة الطبيعية، على رغم أن هذه الموارد هي أساس عمليات التنمية الاقتصادية التي تتطلع إليها شعوبها للارتفاع بمستوى الحياة فيها». ودعا طلبة القيادات الجديدة، في هذه المرحلة من إعادة تخطيط عمليات التنمية في دول الربيع العربي، إلى «تطبيق نظام التقويم البيئي الاستراتيجي، بمعنى أن تحدد كل دولة لنفسها نسبة النمو الاقتصادي التي تأمل أن تحققها، ثم تحدد الأسلوب الذي ستحقق به هذه النسبة، وهل ستعتمد على الزراعة أم الصناعة أم السياحة أم على خليط منها. وذلك للتأكد من أن الأسلوب الذي ستتبعه في تحقيق نسبة النمو التي تراها هو أفضل الوسائل من ناحية الاستخدام الأمثل لمصادر الثروة الطبيعية. ثم يأتي بعد ذلك التقويم البيئي لكل مشروع، لتحديد آثاره السلبية والإيجابية وتنفيذه بناء على نتيجة هذا التقويم».
ماذا يحمل ربيع سورية؟
قد تكون سورية أبرز النماذج الماثلة حالياً لدور التغيرات البيئية في تآكل العقد الاجتماعي، إلى جانب العوامل الاقتصادية والسياسية. فبين عامي 2006 و2011، شهد حوالى 60 في المئة من الأراضي السورية أسوأ جفاف طويل الأمد وأكبر تراجع حاد في المحاصيل الزراعية منذ بدء الزراعة في منطقة «الهلال الخصيب» قبل آلاف السنين. حلّ الجفاف في حوالى 75 في المئة من مناطق شمال شرقي البلاد (مثل محافظة الحسكة) وجنوبها، وخسر الرعيان حوالى 85 في المئة من قطعانهم، ما أثر في 1,3 مليون شخص وفق تقرير للأمم المتحدة عام 2011. وكان حوالى 800 ألف نسمة من السكان الرعاة خسروا كل قطعانهم عام 2009. وعانى حوالى مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي عام 2011. وبات ما بين مليونين وثلاثة ملايين شخص يرزحون تحت فقر مدقع عام 2012. ودفع ذلك آلاف السوريين إلى الانتقال من الأرياف إلى المدن، حيث انضموا إلى آلاف اللاجئين العراقيين الذين توافدوا إلى سورية منذ حرب 2003 ليشكلوا ضغطاً كبيراً على البلاد والسكان.
من المبكر تحديد النتائج البيئية والاجتماعية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للثورة السورية، لكن الدراسة الأميركية تعزو انهيار الزراعات السورية في الأعوام الماضية إلى ضعف الحوكمة وسوء إدارة الموارد الطبيعية والدينامية الديموغرافية. على سبيل المثل، دعمت الحكومة زراعة القمح والقطن التي تستهلك كميات كبيرة من مياه الري، وشجعت تقنيات ري غير كفوءة، في حين استخدم المزارعون المياه الجوفية، وارتفع عدد الآبار من 135 ألفاً عام 1999 إلى أكثر من 213 ألفاً عام 2007. ونزح حوالى 200 ألف مزارع من قرى حلب إلى المدن في كانون الثاني (يناير) 2011، إثر فشل المحاصيل وتحديداً التوابل الحلبية. وعانت بلدة درعا، مهد الثورة السورية، خمس سنوات من الجفاف وشح المياه وسط إهمال رسمي. ومع استمرار موجة الجفاف، يرجح انخفاض إنتاج المحاصيل المروية في سورية ما بين 29 و57 في المئة بحلول عام 2050. وإذا كانت الحال هكذا في ظل سيادة الدولة، فإن الحرب المستعرة حالياً وما سيليها من فوضى المرحلة الانتقالية ينبئان بالأسوأ. ويظهر مفهوم «التهديد المضاعف» الذي أوردته الدراسة الأميركية، خطورة العلاقة بين تغير المناخ والأمن. فقد شهدت سورية، على سبيل المثل، «مزيجاً من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمناخية، أضعف العقد الاجتماعي بين المواطن والحكومة، وقوّى قيام حركة مناهضة».
وفق العالم المصري الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن الأميركية، «ثار الشباب العربي على الوضع القائم المتمثل في حكم مستبد وغير كفوء، وأذهلوا العالم بإصرارهم على التغيير من أجل مستقبل أفضل. لقد أتوا إلى عالم تنقصه الرؤية ويعاني من قيادة ضعيفة وبيئة متدهورة. واستنتجوا في وقت واحد أن لا شيء سيتغير ما لم يأخذوا زمام أمورهم بأيديهم. وهم يسعون إلى تحسين مجتمعاتهم من خلال تنمية رأس المال البشري والموارد الطبيعية».
وينبه الباز إلى أن التنمية الاقتصادية تستلزم إدارة مناسبة للموارد الطبيعية، خصوصاً المياه، مضيفاً: «من المعيب أن تدار أنهارنا وقنواتنا ومجاري مياهنا الأخرى في شكل سيئ جداً. وهي تُعامل في شكل خطير، إذ تُلقى فيها النفايات الصناعية ومياه الصرف والحيوانات النافقة والقمامة، وهذه أدلة على شعوب غير متحضرة. بالمقارنة، قبل آلاف السنين، كان يتعين على كل شخص في مصر القديمة أن يعلن قبل لقاء وجه ربه في الآخرة: «أنا لم ألوث النهر أبداً».
محاولة ليبية… ولكن
لا تزال ليبيا في مرحلة انتقالية يسودها عدم الاستقرار السياسي بعد عامين من إسقاط نظام معمر القذافي، لكنها تبدي بعض الجدية في التعاطي مع القضايا البيئية. في كانون الأول (ديسمبر) 2011، عرض وفدها خلال مفاوضات الأمم المتحدة لتغير المناخ في دوربن في جنوب أفريقيا مشروع «المبادرة الليبية لتغير المناخ»، الذي يقضي بتمويل مشاريع توليد الطاقة من الشمس والرياح بواسطة عائدات النفط. وعلى رغم هذه المقاربة اللافتة، تواجه ليبيا تحديات كبيرة ترتبط بمرحلة إعادة البناء، من أبرزها كيفية إدارة مواردها المائية وتأثير تغير المناخ في ذلك.
«النهر الصناعي العظيم» أحد أكبر مشاريع الهندسة المائية في العالم. وهو يسحب المياه العذبة من جوف الصحراء الكبرى عبر شبكة أنابيب ضخمة إلى طرابلس وبنغازي وسرت ومدن أخرى. أنشأه النظام الليبي السابق بإيرادات الذهب الأسود، لكن استدامته على المحك. فالبلاد تعتمد في شكل أساسي على مورد غير متجدد هو المياه الجوفية. وهذه تستنزفها الزراعات المروية، بينما يفسد غزو مياه البحر المالحة الأحواض الجوفية الساحلية. ويؤدي الاستخراج المفرط للمياه من حوض الكفرة، المشترك بين ليبيا ومصر وتشاد والسودان، إلى انخفاض منسوب المياه وجفاف البحيرات الصحراوية المرتبطة بالواحات. وفي ظل توقع ازدياد أيام القحل السنوية في أكثر المناطق الليبية رطوبة وكثافة سكانية على السواحل من 101 يوم حالياً إلى 224 يوماً، ستجد السلطة الانتقالية في ليبيا نفسها مضطرة ليس فقط إلى توفير الطلب المتزايد على المياه، بل كذلك إلى إدارة التعقيدات المرتبطة بتقاسم المياه مع محيطها الإقليمي والأخطار المحتملة على أمنها المائي.
النمو الأخضر لربيع مستدام
يحذر تقرير «الربيع العربي وتغير المناخ» من أن العالم يدخل حقبة «التضخم الزراعي» (agflation) مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع والمنتجات الزراعية، في ظل اختلاط العوامل البيئية والسياسية والاقتصادية والتجارية وتأثيرها في الأمن الغذائي. ويتوقع أن يشهد الكثير من الدول الفقيرة في العالم أزمات سياسية وأعمال عنف أو «ثورات خبز»، في ظل ارتباط تحديد شكل الأنظمة والاستقرار المنشود ارتباطاً عضوياً بالنزاعات وتغير المناخ وحركة النزوح والهجرة.
ويعتقد الباحثون أن مواجهة تأثيرات تغير المناخ ستكون ضرورية لضمان استقرار طويل الأمد وتأمين الشرعية لحكومات دول المنطقة، خصوصاً مع بلوغ معدل البطالة (للفئة العمرية بين 15 و24 سنة) في الشرق الأوسط 25,4 في المئة، وفي شمال أفريقيا 24,3 في المئة، وهي النسبة الأعلى في العالم وضعفا المعدل العالمي البالغ 12,4 في المئة. فالشعوب العربية، المطالبة بالحرية والعدالة والكرامة وفرص العمل والتمثيل السياسي، ستطالب حكوماتها أيضاً بتوفير الموارد الضرورية ليس فقط للبقاء، بل للنمو والازدهار كذلك. ويرتبط السعي إلى ذلك بتوافر الموارد الطبيعية المهددة بتغير المناخ في المنطقة وخارجها.
وإذ يغيب عن الدراسة كلياً تقويم أحد أبرز الأخطار المحدقة بالمنطقة في السنوات القليلة المقبلة، وهي عطش اليمن عام 2020، تقترح مواجهة «أزمة الموارد» في شكل عام، عبر تكافل إقليمي وعالمي يسعى إلى بناء مجتمعات أكثر مقاومة وتكيفاً واستدامة، وأكثر استجابة لرياح التغيير الاجتماعية والطبيعية. وتشدد في ذلك على تبني اقتصادات خضراء، مستندة إلى تقارير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) في التوصية بـ «تخضير» خُمس قطاع البناء وتحسين كفاءة الطاقة والمياه في المباني. فمن شأن ذلك أن يؤمن 4 ملايين وظيفة، وإعادة الكلفة في غضون سنتين إلى سبع سنوات عبر تخفيض فاتورة الطاقة، فضلاً عن توفير بيئة عملية للتخطيط المدني وتطوير بنى تحتية صديقة للبيئة على المديين المتوسط والبعيد.
يقول أمين عام المنتدى نجيب صعب إن «عدم توافر وظائف لائقة كان من المطالب الرئيسة التي دفعت المواطنين الى الشوارع والساحات». ويرى أن «التدهور البيئي وسوء إدارة الموارد من المسببات الكبرى لهذا، وأن التحول إلى اقتصاد أخضر يساعد في إدارة أفضل للموارد كما في إيجاد فرص عمل دائمة». لكن ذلك يتطلب التحول من «الاقتصاد الافتراضي» السائد، المبني أساساً على المضاربة في الأسواق العقارية والمالية، إلى «اقتصاد واقعي» يركز على الإنتاج المستدام، الذي وحده يمكن أن يحمي رأس المال الطبيعي ويولد وظائف طويلة الأجل.
لا يزعم تقرير «الربيع العربي وتغير المناخ» أن تغير المناخ هو سبب الثورات التي هزت العالم العربي خلال السنتين الماضيتين، لكنه يورد أدلة مقنعة بأن عواقبه هي عوامل إجهاد يمكن أن تشعل خليطاً متأججاً من الأسباب الكامنة التي تفجر ثورة: «ربما كان محتماً أن يأتي الربيع العربي بطريقة أو بأخرى، لكن السياق الذي أتى به ليس اعتباطياً. قد لا يكون الاحتباس الحراري هو سبب حدوث الربيع العربي، لكنه ربما بكر في حدوثه».