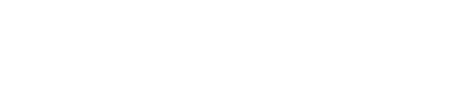تترقب الأرض هذا اليوم (الأربعاء) بفارغ الصبر، فهو يعد يوماً تاريخياً لها، وإما أنه سيحقق مكاسب جديدة لهذا الكوكب الذي نعيش عليه وتصدر خلاله قرارات حازمة لإصلاح الكون، أو أنه سيحبط العالم الذي جلس يترقب هذا الاجتماع ما يقارب ربع قرن من عمر البشرية، وسيبقي الحال على ما هو عليه؛ مزيد من الشعارات ومزيد من الخيبات والتدهور للبيئة ولحياة الإنسان الذي يسكنها ولمستقبل أجياله.
أكبر احتفالية عالمية تنعقد اليوم في “ريو دي جانيرو”، الساحرة في طبيعتها والملوثة بفعل الإنسان، ابتداءً من حكايات الفقر والبطالة إلى التدهور البيئي فيها، تستقبل أبرز رؤساء العالم ونحو خمسين ألف شخصية ذات طابع رسمي رفيع أو تضم ممثلين لمنظمات شعبية من شتى بلدان العالم يحضرون إليها للاستماع إلى ضجيج هذا الكون والتحديات التي تواجهه، وأيضاً الإنجازات التي تحققت، والمشاريع التي ستولد للمستقبل والقرارات التي سيتم الاتفاق عليها لضمان بيئة مستقرة يستطيع أن يعيش عليها الإنسان بسلام.
لكن “قمة الأرض” التي تعود إلى الانعقاد في البرازيل بعد 20 عاماً من اجتماعها الأول، بالتأكيد ستختلف قضاياها عن تلك التي ناقشتها في ذلك اللقاء. خلال هذا الزمن الذي يفصل بين المحطتين تغير وجه العالم عشرات المرات، حلّت فيه حروب ومجاعات وشهد صراعات وانقرضت حيوانات وسلالات وظهرت أمراض وأوبئة. جفت بحار وأودية، واستشرى فقر مدقع في بقاع جديدة وأزمات في دول لم يتوقع أحد أن تحل بها كوارث بهذه البشاعة وهذه الخسائر. سخنت الأرض حتى درجة الغليان، وارتفعت مستويات الماء في بحار وازدادت حموضتها، وذابت جبال عمرها آلاف السنين من الجليد وزاد ثقب الأوزون اتساعاً. زلازل وفيضانات وأعاصير وكوارث بيئية… حدث ذلك بدرجات وأشكال في كل زاوية من زوايا هذا البيت العالمي الذي نسكنه.
وإذا كان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك قد حذّر العالم في بداية القرن العشرين من أن “بيتنا يحترق وأنظارنا متجهة إلى جانب آخر”، عندما خاطبهم خلال قمة جوهانسبرج العالمية للتنمية المستدامة، فإن هذا البيت الذي يضمنا جميعاً احترق منذ ذلك التاريخ عشرات المرات وتصدعت أركانه من كثرة التعديلات وعمليات الترميم ولفافات التجميل التي نحاول بها أن نصلح في جنباته.
وفي الإمارات، عندنا تجربة للمساهمة بدور في إصلاح هذا الكون، بدأناها قبل ما يزيد على ثلاثين عاماً، كانت تجربة حقيقية لم تقصد رفع شعارات نحقق منها مكاسب وقتية أو نهدف إلى المتاجرة بنصرة البيئة. كانت ضمن حدود بيئتنا الصغيرة تسعى للبحث عن حياة أفضل لهذا الإنسان الذي يسكن هنا.
تمثلت هذه التجربة في تشجير الصحراء، وزراعة عود أخضر في بقاع قاحلة لا ماء فيها ولا عمران ولا يسكنها كثير من البشر. كانت تلك رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله تعالى، فهو الذي أطلق المبادرة وحرص على تنفيذها ومتابعتها ورعايتها حتى عندما كبرت وقويت جذور تلك الغابات. خالفه الكثير من الخبراء الأجانب الذين وجدوا أن هذه الصحراء لا يمكن أن تنبت ولا تقوى فيها هذه الزراعة، وسمع وجهات نظر كانت تقول إن ذلك سيستنزف المخزون المائي وأن هذه الأشجار ستموت في النهاية، لكن كانت عنده، رحمه الله تعالى، إرادة وكانت له رؤية بعيدة المدى.
وعندما نشاهد الناس في بقاع الدنيا المختلفة الذين أعطاهم الله مقومات اللازمة كي يزرعوا أراضيهم ولم يفعلوا ذلك فبقيت بلدانهم جرداء طاردة للحياة أو كئيبة للناظر إليها. تصيبنا الصدمة والحيرة معاً، كيف كان بإمكانهم أن يزرعوا ويغيروا البيئة التي تضمهم والتي سيعيش عليها أحفادهم يوماً نحو الأفضل ولم يفعلوا ذلك؟! ماذا لو كان الشيخ زايد قد صدّق كلام أولئك الخبراء أو استجاب لقلق وتخوفات ذلك الفريق الذي كان يطالب بالمحافظة على الواقع كما هو؟ وهل سيكون حاضرنا هكذا؟ وكيف سيكون لون حياتنا من غير منظر الزرع في كل مكان؟
دولة الإمارات تشارك بوفد كبير في هذا الملتقى التاريخي الهام، وستعرض تجربة زراعة الصحراء، وستتحدث عن أدوار ومشاريع هامة تبنتها خلال السنوات الأخيرة، مثل دعم مشاريع الطاقة البديلة، وحلم “مصدر” الذي أصبح واقعاً وتجربة مهمة للدولة ومحط أنظار ومتابعة العلماء والشركات الدولية المتخصصة، واستضافتنا لمنظمة الطاقة المتجددة “آيرينا”، وكذلك مشروع الإمارات الأكبر في عمليات دعم السلم والاستقرار العالمي ومشاريع تنمية الدول المختلفة والمساعدات الإنسانية التي قدمتها طوال السنوات الماضية لفقراء العالم أينما كانوا كواجب إنساني تبادر له، لا تنتظر دعوة من أحد لتقوم به ولا تنتظر الشكر عليه من أحد أيضاً.
وفي عقد الثمانينيات نتذكر كيف كان الإعلام يبرز على صفحاته صورة أكبر حبة طماطم أو خيار أو مانجا عملاقة .كانت تتبارى المزارع في رش الكيماويات والأسمدة المركبة والمبيدات، لتحصل على الحجم الأكبر والإنتاج الأكثر والأسرع. وكانت المياه الجوفية تهدر على هذه الزراعات الملوثة بالسموم. كنا كذلك نسمع أنين هزات الجبال بفعل الكسارات التي كانت ترج الأرض وتسقط قامات تلك الرواسخ التي هي من ثوابت المكان لتنشر سحابات الغبار والتلوث على بيوت سكان القرى هناك.
في تلك الفترة كانت الصورة المألوفة أن يفتح سائق التاكسي الآسيوي باب سيارته ويبصق كما يحلو له في أي بقعة يصادفها، أو يرمي نفاياته في الشارع، أو يلصق بقايا “اللبان” الملون وجراثيمه على أي جدار يمر عليه. كنت تجد نفايات البناء ترمى في أي واد أو قرب الصحراء أو وسط البحر، وتشاهد بشراً من ألوان مختلفة يتركون فضلات أكلهم في الحدائق العامة.
تغيرت تلك الصورة المألوفة آنذاك، بل نقول إنها انقرضت إلى غير رجعة بفضل برامج وحملات التوعية وتثقيف البشر الذين يسكنون هنا، وأيضاً بسن القوانين والتشريعات التي تحمي البيئة والإنسان. تجربة صناعة الوعي وفرض ثقافة التعامل مع البيئة واحترامها عند هذا الخليط من الجنسيات المتعددة، هو مادة غنية تستحق أن تعرض وأن يستفيد منها الآخر.
اليوم عندما تتوقف عند أغلب محطات البترول تشاهد مضخات جاهزة لا تقترب منها أية سيارة مكتوب عليها “غاز طبيعي”، ونتساءل: من سيستخدم هذه، ولماذا هذه الخسائر والمشاريع غير المجدية؟ إنه يشبه السؤال الذي طرح في الماضي: لماذا نزرع الصحراء؟ هل سينبت فيها عود أخضر يوماً؟!
سعيد حميدان – جريدة الاتحاد